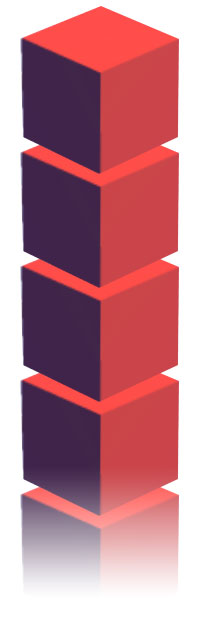لا
يزال التجمع الدستوري
الديمقراطي يمسك السلطة
منذ نصف قرن، حيث
تهاوت على إثر سقوط المعسكر
الاشتراكي كل الأحزاب
الشيوعية
الشمولية، ما عدا الحزب
الشيوعي في الصين وكوريا
الشمالية، وهي
الأحزاب التي كانت تدمج
الدولة بالحزب دمجا كاملا.
كما قد يكون "التجمع" أضخم
حزب في العالم من حيث عدد
المنخرطين
فيه، مقارنة بعدد السكان.
فالمصادر الرسمية تزعم
بأن حاملي بطاقة
التجمع هم حوالي مليونين
ونصف مليون تونسي.
يضاف إلى ذلك أنه الحزب
الذي لازم حياة ومسيرة
أجيال متلاحقة من
التونسيين، وذلك منذ
مطلع العشرينات (حين تأسس
الحزب الحر
الدستوري على يد الشيخ
عبد العزيز الثعالبي)دون
توقف أو ارتخاء.
كما أنه الحزب الذي تَـعوّد
أن يكسب الأغلبية الساحقة
من المقاعد
في البرلمان والبلديات
دون عناء كبير، وربما
سيبقى مُـهيمنا على
الدولة والإعلام والمجتمع
المدني والحياة الثقافية
والاقتصادية
والاجتماعية لفترة قد
تُـغطي العشرين سنة الأولى
من هذا القرن.
ويتفق الكثيرون على القول
بأن الرئيس بن علي هو الذي
أنقذ الحزب
الدستوري من الانهيار
التام بعد أن كان مهيئا
خلال الفترة
الأخيرة من حكم بورقيبة
للسقوط النهائي، وقد
تساءل التونسيون
خلال الساعات الأولى
من سماعهم لخبر إزاحة
الرئيس السابق عن مآل
الحزب الاشتراكي الدستوري.
وحتى بعد أن تم تعيين الهادي
البكوش، الشخصية السياسية
المحنكة
على رأس أول حكومة تشكّـلت
بعد التغيير، بقي البعض
يراهن على
إمكانية إنشاء "حزب رئاسي"
جديد، مثلما حصل فيما
بعد في الجزائر،
يكون بديلا عن الحزب الدستوري
الذي بدا حينها هرما وفاقدا
لمبررات استمراره.
لكن هذا المقترح سرعان
ما استبعدته القيادة
السياسية الجديدة،
التي قررت المراهنة على
نفس الحزب من خلال إعادة
هيكلته وتجديد
عناصره، وتغيير اسمه
وتعديل خطابه.
فالرئيس بن علي كان في
حاجة عاجلة إلى "حزب يدعم
سياسته ويحفز
الجماهير ويجمعها حول
خياراته"، حسب ما ذكره
زهير المظفر في
كتابه "من الحزب الواحد
إلى حزب الأغلبية"، وهي
مهمة لا يمكن أن
ينجزها "حزب كوادر يعتمد
على نخبة، مهما كان إشعاعها".
حصل "تجديد" الحزب خلال
ما سُـمي بمؤتمر "الإنقاذ"
للتجمع
الدستوري الديمقراطي
(يوليو 1988)، حيث تم اللجوء
إلى أسلوب
تعيين المسؤولين في جميع
هياكل الحزب، كما تم تكليف
المكتب
السياسي الجديد بتعيين
هيئات الجامعات (في المحافظات)،
التي
اقترحت بدورها قائمات
اختيرت من بينها هيئات
الشعب (الخلايا
المحلية)، والتي تولّـت
بدورها انتداب منخرطين
جدد في صفوف الحزب.
وفي خاتمة أشغال المؤتمر،
قامت الرئاسة بتعيين
125 عضوا من بين
200 ليشكّـلوا اللجنة المركزية
للحزب الحاكم، واعتُـبر
ذلك يومها
إجراءً استثنائيا.
ونظرا إلى أن نسبة تجديد
النسيج الحزبي بلغت 80% وتمت
في وقت
قياسي، فقد شعر "البورقيبيون"
(نسبة للرئيس الراحل الحبيب
بورقيبة) بأنهم أصبحوا
أقلية غير فاعلة في حزبهم،
واعتبروا يومها
أن "حزبهم التاريخي أُفرغ
من مناضليه، وأنه تحوّل
إلى جزء من
إدارة الدولة"، رغم أن
بعضهم لا ينكر بأن الحزب
الدستوري توقف عن
النمو السياسي منذ أن
حوّله أول رئيس للجمهورية
التونسية (1903 -
2000) إلى جهاز بيروقراطي.
وفي المقابل، أصبحت القيادة
السياسية الجديدة تتصرّف
في جهاز
حزبي تمتد شرايينه عبر
كل أحياء وقرى البلاد
ومدنها، وتستجيب
كوادره لكل ما تفرضه حاجيات
المرحلة الجديدة.
وقد حصل ذلك بسرعة فائقة
دون مقاومة تذكر من الحرس
القديم، بل إن
عملية تطويع الحزب تمّـت
بتعاون كبير من جانب كوادر
أساسية أدركت
بأن الصفحة القديمة قد
طُـويت نهائيا، وإن حاولت
أن تحافظ على
الإرث السياسي والثقافي
للمدرسة البورقيبية.
ورغم
أن الكوادر الجديدة التي
التحقت بالأجهزة الحزبية
لم تكن تملك
خبرة الدستوريين القدامى
أو شعورهم العميق بالانتماء
الحزبي،
وكثير منهم ليس له تاريخ
سياسي أو تجارب في الحقل
العام، لكنهم
أثبتوا انضباطهم وولاءهم
الكامل، رغم عملية التجميع
التي خضعوا
لها في البداية، وهي نوع
من التصنيف الضمني بين
قدامى أو
دستوريين، وبين جدد أو
"نوفمبريين"، غير أن عملية
الانصهار
تسارعت بقوة، وحالت دون
أن تعكس التسمية الجديدة
وهي "التجمع بدل
الحزب"، تنوعا داخليا
حقيقيا.
ومما ساعد على عملية تعبِـئة
الحزب بأنصار جدد، حالة
التعطش التي
كانت تشعر بها قطاعات
واسعة من "النخبة" للمشاركة
من داخل
الأجهزة السياسية بعد
الإقصاء الذي عانت منه
كثيرا خلال المرحلة
السابقة (من 1956 إلى 1987).
لهذا، جاء انخراطها واسعا
وسريعا في صفوف التجمع
الدستوري
الديمقراطي، بمن في ذلك
جامعيون ومستقلون وأعضاء
سابقون في أحزاب
وتيارات سياسية معارضة،
ظنوا بأن تحقيق أهدافهم
عبر أجهزة السلطة
قد أصبح أمرا ممكنا، إذ
كانت الاعتبارات والدوافع
الشخصية هامة
ومحددة في هذا المجال،
إلا أن الشعارات التي
تبناها "التجمع"،
والتغيير الذي طرأ على
خطابه السياسي كان في
البداية عاملا
مُـهمّـا لتغذية حالة
الاستقطاب الشديد في
البلاد (بين السلطة
وحركة النهضة) الذي استفاد
منه الحزب الحاكم في تلك
المرحلة،
وأقرت به معظم أحزاب المعارضة.
وجاء في بيان صدر حينها
عن حركة الوحدة الشعبية:
"إن ما حصل في
الحزب الحاكم محاولة
إيجابية لإنقاذ حزب أفرغه
النظام القديم من
كل مقومات الحزب، وحوّله
إلى مجرد عون للدولة وامتدادا
لها". أما
التجمع الاشتراكي التقدمي
(الذي أصبح يسمى اليوم
الحزب
الديمقراطي التقدمي)،
فقد رأى آنذاك أن "التغييرات
التي حصلت في
جهاز الدولة، سوف تعطي
حظوظا جديدة للحزب الحاكم
تمكّـنه من
استرجاع نوع من المصداقية
الشعبية"، بل ذهب يومها
(حزب الوحدة
الشعبية) إلى حد القول
"نحن مع هذا الهيكل الجديد
ومع تدعيمه".
ولم تمض سوى فترة وجيزة،
حتى تحول هذا الجسم "القديم-الجديد"
إلى
جهاز وظيفي فعال. وقد استفاد
هذا الجهاز كثيرا من المواجهة
الكبرى التي حصلت بين
السلطة وحركة النهضة
في بداية التسعينات،
رغم أنه لم يحتفظ لفترة
طويلة بإدارة هذا الملف
وغيره من الملفات
الحساسة.
وبالرغم من استمرار نداءات
أحزاب المعارضة بضرورة
الفصل بين
الحزب والدولة، غير أن
هذه الدعوة بقيت طوباوية
في ظل موازين
القوى الراهنة، لأن الكثير
من الباحثين في مجال العلوم
السياسية
يعتقدون بأن عملية الفصل
ستعني نهاية الحزب الحاكم،
وبالتالي،
فقدان السلطة لإحدى مقومات
وجودها واستمرارها وسيطرتها.
فالحزب الحاكم، يبقى
رغم خضوعه لأجهزة أقوى
منه وتتمتع بصلاحيات
أوسع من صلاحياته، آلة
ضخمة لحماية التوازنات
الراهنة والمصالح
المهيمنة.
عندما تم استبدال اسم
الحزب الحاكم وعوضت صفة
"الحزب" بصفة "التجمع"،
ظن المراقبون أن ذلك سيندرج
ضمن حركية ديمقراطية
داخلية، خاصة
وقد التحق بالتنظيم عناصر
كثيرة تنحدر من تجارب
ومشارب سياسية
وأيديولوجية متعددة.
وبدأ الملاحظون يحاولون
رصد احتمال بروز
تيارات أو أجنحة تضفي
على الحياة الداخلية
للتجمع حركية ودلالات،
مثلما حصل من قبل في
صلب الحزب الدستوري،
الذي لم يخل طيلة
تاريخه من صراع (خفي
أو معلن)بين الأجنحة.
لكن شيئا من ذلك لم يحدث
بعد تغيير السابع من نوفمبر،
وما سجل من
وقائع لم ترتق إلى الحجم
الذي يمكن اتخاذها مقياسا
لمعرفة اتجاه
القوى المختلفة داخل
هذا الجسم الضخم. ولعل
ذلك هو الذي يفسّـر
حالة "الاستقرار التام"
الذي عرفته الحياة الداخلية
للحزب الحاكم
بشكل يكاد يكون فريدا
من نوعه في تاريخ الأحزاب
السياسية، فحتى
الخلافات الصغيرة
التي قد تطفو أحيانا،
سرعان ما تُـطوّق وتتحول
إلى حالات فردية هامشية.
وهكذا، تصعب المجازفة
اليوم بالحديث عن وجود
تيارين مثلا، أحدهما
"متشدد" رافض لإحداث
أي انفتاح داخلي، وآخر
ذو توجه "إصلاحي"
منفتح. لكن ذلك لا يمنع
من وجود عدد واسع من الكوادر
التجمعية
التي - رغم عدم استعدادها
تقديم تنازلات فعلية
وهامة للمعارضة -إلا
أنها لا تخفي انزعاجها
مثلا من استمرار تدهور
أوضاع الإعلام،
وحدوث تجاوزات خطيرة
في مجال حقوق الإنسان.
لكن الأغلبية الساحقة
من الكوادر والقواعد
تفضّـل عدم التصريح
بآرائها ومشاعرها،
وتعتبر أن الجلوس على
الربوة والتظاهر
بالانضباط الحزبي
أسلم وأبعد من الوقوع
في مطبات قد تؤدي إلى سوء
المنقلب.
صلاح
الدين الجورشي - تونس
|